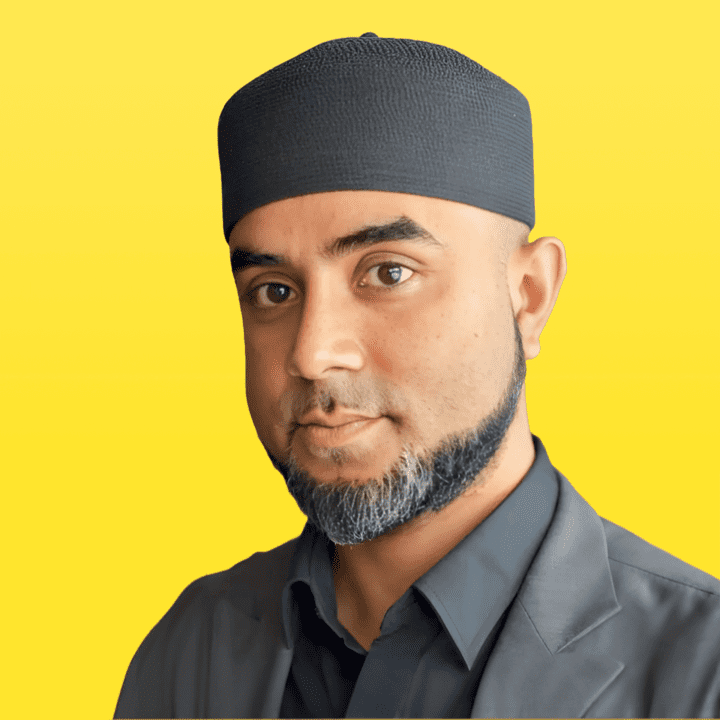مقدمة
نحن المسلمون منقسمون يا أخي، ولن نتفق أبداً، لأن لدينا عقائد مختلفة، والموضوع أكبر من أن يُطاق. ولا مفرّ من أن نتقبّل أننا لن نستطيع أبداً حلّ هذه المشكلة.1
لفت هذا الاقتباس انتباهي أثناء تحضيري لهذا المقال، حيث يجسّد التحدي الأبرز الذي نواجهه على المستوى الجماعي. فانقسامنا الواضح هو أحد أكثر المواضيع تداولاً وتكراراً في حواراتنا الداخلية، والتي غالباً ما تبدأ بعبارة مثل «تعاني الأمة من كذا وكذا من المشاكل، ولا بد من العمل ولكن ذلك غير ممكن لأننا لسنا متحدين!». يمثّل السعي إلى وحدة المسلمين عنوانًا جذابًا بالنسبة لمعظمنا، لكن تحقيقه صعب المنال لكوننا فيما يبدو عاجزين عن الاتحاد كأمة على مستوى العالم، أو لأننا منشغلون في قضايا أكثر إلحاحاً في محيطنا القريب. ولكن رغم أن الأمة تمرّ الآن بأكثر حالاتها تفككاً في تاريخها على المستوى السياسي والثقافي، مع انقسامات بين مختلف الدول القومية والجماعات العرقية والتوجّهات الطائفية، فمن الخطأ الاستخفاف بأهمية إحياء الطموح إلى تحقيق الوحدة الأمتيّة في قلوب وعقول أغلب المسلمين. ولنا أن نقول أنّ سدّ الفجوات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والعقائدية هو أمر غير واقعي أبداً ولا جدوى تُرجى من السعي لتحقيقه، أو أن نقول إنّ هذه المهمة العظيمة هي مسؤولية جماعية وفردية نمتلك جميعاً القدرة على المساهمة الإيجابية في تحقيقها.
أطرح في هذا المقال ثلاث أفكار عامة، أولها وجود رغبة فعلية في تعزيز التماسك بين المسلمين، رغم الانقسامات المختلفة والصراعات المذهبية البينية التي يمكن ملاحظتها اليوم. وثانياً، أن التضامن الأمتي ليس مجرد رغبة فحسب، بل هو موجود بالفعل على المستويات الدينية والاجتماعية والثقافية المشتركة ضمن أشكال العمل الاجتماعي والفني والتعليم والتجارة والصدقات والسفر والسياحة المستمدة من الإسلام بين مختلف المجتمعات حول العالم، والتي «تربط بين الأفراد والمؤسسات، وتُثبِّت هذا الترابط بينما تُحدث فيهم تغييراً وتحوّلاً في الوقت نفسه».2 إنني أقدم هنا لمحة موجزة عن الرغبة المعاصرة في تحقيق الوحدة السياسية للمسلمين، وألفت انتباه القارئ إلى أمثلة على وجود الوعي الأمتّي حتى بعد سقوط الخلافة الإسلامية، وأُلقي الضوء على ردود أفعال العلماء والحركات الإسلامية، وأقدّم نظرة عامة على إمكانات الشباب المسلم في إحداث التغيير. وأختم ثالثاً بأنّ تحقيق هذه الوحدة العظيمة يتطلّب منا إعادة النظر في فرضياتنا الحالية، وتطوير أساليب جديدة لتجاوز خلافاتنا وبناء مستقبل أمتيّ بديل يتجاوز الحدود المُتوهَّمة في العقول.
الشعور الأمتيّ في التاريخ الحديث
يتمتّع مفهوم الأمة بأهمية بالغة في الخيال الإسلامي، لأنه يعبّر عن مجتمع أخلاقي بامتياز و«مرن غير جامد؛ فهو يشير إلى الإسلام بشموليّته ضمن حدوده الواسعة التي تحدد الهوية الإسلامية الجامعة».3 فقد أسست النصوص المُحْكَمة في القرآن والسنة النبوية لمبدأ وحدة المسلمين، وعقيدة التوحيد تقدّم الإلهام النموذجي للوحدة الأمتيّة، والتي تتمثّل في الشعائر التعبدية والسلوكيات الاجتماعية المشتركة التي تُظهر تشابهاً ملحوظاً بين بلدان متباعدة كالمغرب وماليزيا. ويتماهى المسلمون في مختلف أنحاء العالم مع فكرة الوحدة العابرة للحدود الوطنية، ويلمسون في ذاتهم مفهوم الأمة كمرجع للتواصل والتعاون فيما بينهم. كما تتجسّد فكرة وحدة المسلمين كتعبير عن الهوية الإسلامية العابرة للحدود الوطنية في المجال العام للعالم الإسلامي، وذلك من خلال تطبيق التضامن الأمتي.4 وفي هذا الصدد، يقول عالم السياسة إعجاز أكرم:
إن التطلّعات الإسلامية التي تحملها الأمة لم تتلاشَ، كما أن قدرة الجماعات والأيديولوجيات وشبكات التواصل العابرة للحدود الوطنية على اختراق هذه الحدود تشهد على أن مشاعر الانتماء للمجتمع المسلم أقوى مما يخيّل للناس عموماً.5
لقد تمثّلت الوحدة السياسية للمسلمين رمزياً عبر التاريخ في مؤسّسة الخلافة، التي ظلّت متجذرة في وعي المسلمين حتى مع تفكيك سلطتهم السياسية الجامعة وقبل المسلمون بتعدّد دولهم. ويبدو أنّ هذا الشعور يتصاعد اليوم، كما تُظهر العديد من استطلاعات الرأي أنه رغم اختلاف آراء المسلمين تجاه النظام الدولي، فإنهم عموماً يريدون دوراً أكبر للإسلام في الحياة السياسية.6 ويتجلّى الشعور الأمتي في المساجد، والمؤسّسات الدينية الوطنية، والمواثيق التأسيسية للمؤسسات الإسلامية الدولية، وتُبرز غالبية منظمات العمل الإسلامي العابرة للحدود الأكثر تأثيراً في العالم، والتوجّهات الفكرية المتعلّقة بها، القيم الأمتيّة بشكل ضمني أو صريح، وتقدّم الإلهام الدافع للتعاون الأكبر بين المسلمين. يشهد لهذا مثال حديث نسبياً، حين نادى رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد بـ«نهضة إسلامية» تقودها تركيا وماليزيا وباكستان، خلال زيارة رسمية إلى تركيا أجرى فيه محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام ٢٠١٩.7 ورغم أن محمد ورئيس وزراء باكستان السابق عمران خان لم يعودا في موقع السلطة الآن، لا يزال الشوق إلى هذه النهضة موجوداً، بل وتجدّد مع انتخاب الرئيس الماليزي الجديد أنور إبراهيم8 الذي يحمل نفس الرؤية الأمتيّة. كل هذا يشير إلى إمكانية ظهور «هلال الأمل» الذي «يربط الحكومات والشعوب في مشروع البناء كبديل للنظام العالمي الإسلاموفوبي الحالي».9
يتجاوز معظم المسلمين الحدود الوطنية في رؤيتهم للعالم، وسواء كانوا جزءً من مجتمعات الجاليات المهاجرة الكبيرة، أو مهاجرين جدد، أو طلاباً، أو لاجئين، أو رجال أعمال، فإنهم حريصون على الحفاظ على العلاقات العابرة الحدود مع بلدانهم الأصلية من خلال الزيارات المنتظمة وإرسال التحويلات المالية ومتابعة التطورات الاجتماعية والسياسية «في أوطانهم» عن كثب. وغالباً ما يكون هذا الشعور بالانتماء القائم على الإيمان «مرتبطاً بالأماكن التي يُستضعف فيها المسلمون، بل ويتعرّضون فيها للاضطهاد، حيث تصبح مصطلحات مثيرة مثل ‹القدس› أو ‹سربرينيتشا› أو ‹الروهينغا› دلالة على أمة مكلومة».10
إنّ الوصية الشهيرة والمقدّسة التي وصف فيها رسول الله صلّى الله عليه وسلم الأمة والمسلمين بأنهم «كالجسد الواحد»، تقدّم النسيج الجامع الذي يعزز الهوية الدينية فوق الانتماء الوطني. ويمكن رؤية أكثر مظاهر التضامن الأمتي وضوحاً على مستوى القاعدة الشعبية من خلال المظاهرات الداعمة للمظلومين في فلسطين المحتلة أو كشمير، أو المساعدات الإنسانية المقدّمة بعد الفيضانات المدمرة الأخيرة في بنغلاديش وباكستان.
هذا التعبير عن التضامن مع إخواننا المسلمين نراه في حياتنا وحواراتنا اليومية وأثناء أداء الصلوات، ويمكن القول إن له تأثيراً «جاذباً» و«دافعاً» في آن معاً.11 أما الجاذب فيتمثل في تفاعل عوام المسلمين الشديد مع الاضطهاد الذي يتعرّض له إخوانهم في أماكن مثل ميانمار، وأما الدافع فيتمثل في الطريقة التي تدعو بها دول مثل إيران والسعودية إلى الوحدة الإسلامية من خلال المؤسسات والمؤتمرات والبيانات والتبرعات، بينما تسعى إلى تحقيق أهدافها السياسية الخارجية. ورغم أن الواقعية السياسية غالباً ما تتفوق على الخطاب الديني في أمور السياسة، يبقى استحضار هذه الأنظمة لمفهوم الأمتيّة أمراً يؤكّد على القوة الثابتة لعنوان الوحدة الإسلامية.
تحتل أرض فلسطين المباركة مكانة خاصة في قلوب المسلمين، وكانت معاناة شعبها المضطهد محور الوعي الأمتي عبر الأجيال، حيث لبّى العديد من المسلمين من مختلف أنحاء العالم نداء نصرة الفلسطينيين. ومن الأمثلة على ذلك جهود الطيار البنغالي البطل سيف الأعظم، الذي شارك مع سلاح الجو الأردني في حرب عام ١٩٦٧ بين العرب وإسرائيل وأسقط ثلاث طائرات إسرائيلية.12 وجاءت لاحقاً لحظة أمتيّة محفّزة في أعقاب هجوم الإسرائيليين على المسجد الأقصى وإحراقه عام ١٩٦٩م، والذي أثار غضباً واسع النطاق في جميع أنحاء العالم الإسلامي. ففي أعقاب هذه الحادثة، دعا مفتي القدس أمين الحسيني والملك فيصل إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة ما حدث ما أنتج زخمًا أدى إلى إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي. والمثال الثاني الأقل شهرة هو تطوع حوالي ٨٠٠٠ شاب بنجلاديشي للقتال من أجل تحرير فلسطين، بعد الغزو الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢م.13
في الآونة الأخيرة، تعزّزت مكانة القضية الفلسطينية من خلال مواقف المشاهير والساسة البارزين الذين أعربوا عن دعمهم لها. ففي عام ٢٠٢١م، انضم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى ملايين مستخدمي تويتر الذين روّجوا لحملة دعم الفلسطينيين بعد هجوم الإسرائيليين عليهم، وأصبح وسم WeStandWithPalestine# الأكثر تداولاً عالمياً. تعكس مثل هذه المواقف التضامنية شعوراً بالمسؤولية المشتركة تجاه المسلمين الآخرين الذين قد يكونون خارج نطاق احتكاكنا اليومي، وتُبرز الدعم المستمر الذي يستحقه الفلسطينيون والنشاط الأُمَّتي في الممارسة العملية.
لقد تجلى الوعي الأمتيّ بشكل واضح خلال بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر، حيث بدرت من بعض فرق الدول الإسلامية أفعالًا ترمز إلى التديّن الكامن في قلوبهم، كالسجود على أرض الملعب بعد تسجيل الأهداف ورفع أعلام «فلسطين حرة». حتى أن وصول المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي، في إنجاز مبهر، تزامن مع تنظيم الصلوات جماعة في إندونيسيا، وكان سبباً لخروج ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم للاحتفال في الشوارع.14 ولذا، علّق أحد الصحفيين بعد فوز منتخب المغرب على إسبانيا فقال:
المغرب بلد مسلم، وقبل ركلات الترجيح في دور الستة عشر ضد إسبانيا تلا لاعبو المنتخب سورة الفاتحة، أول سورة في القرآن الكريم. ثم بعد تأهّلهم إلى الدور ربع النهائي والفوز فيه ركض لاعبوا الفريق إلى جماهيرهم وسجدوا على أرض الملعب، معلنين في هذه الخطوة للعالم فخرهم بكونهم مغاربة ومسلمين أيضاً، الأمر الذي أشعل احتفالات الفرح في جميع أنحاء العالم الإسلامي.15
تُعدّ المشاركة في الإغاثة الإنسانية من أبرز الأمثلة العملية على التضامن الأُمَّتي، فالمنظمات الإسلامية غير الحكومية تركّز في معظم أعمالها على هذا الجانب من التضامن. ومن الأمثلة العديدة على ذلك عمل الهيئة الخيرية الإسلامية الدولية من الكويت، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية من السعودية، ومؤسسة رعاية الأمة (Umma Welfare Trust)، ومؤسّسة أمة واحدة (One Ummah) الخيرية في بريطانيا.16 هذا الشعور القوي بوجوب خدمة الأمة يدفع البعض للانتقال من مجرد تقديم المساعدات الخيرية إلى مساعدة المحتاجين والمضطهدين بشكل مباشر، حيث سافر العديد من المسلمين إلى ساحات الصراع خلال الحرب الأفغانية الأولى في الثمانينيات، والبوسنة في التسعينيات، ومؤخراً إلى سوريا حيث سافر مئات المسلمين لنصرة السوريين وتقديم المساعدة الطبية لضحايا الحرب. كما يمكن ملاحظة هذا الشعور الأمتيّ في أماكن بعيدة وغير متوقّعة مثل أيسلندا والسلفادور، حيث يتواصل المسلمون مع إخوانهم ويتعاطفون مع القضايا المذكورة أعلاه. وهذا المفهوم الذي يختصّ به دين الإسلام، في إقرار واجب المسلم تجاه إخوانه المسلمين، أحد المواضيع التي يتكرّر الحديث عنها على منابر الجمعة حول العالم، حيث يدعو الأئمة بالنصر للأمة ووحدتها كما نرى ونسمع جميعاً في البلدان الإسلامية والمجتمعات الغربية.17
من يريد الخلافة؟
تجسّد طموح الوحدة السياسية للمسلمين تاريخياً في مؤسسة «الخلافة»، ولكن المؤسف أن مصطلح «الخلافة» بات مرتبطًا بمعانٍ سلبية نتيجة ممارسات جهات مثل تنظيم داعش، وبات يصعب الحديث عن الخلافة علناً نظراً لهذا الربط المغلوط بين الخلافة والتطرّف والإرهاب. وفي الواقع، فإن الخلافة تعلّقت في جوهرها، كما أشار المؤرخ هيو كينيدي (Hugh Kennedy) في كتابه «الخلافة: تاريخ فكرة» (The Caliphate: The History of an Idea)، بقيادة وتنظيم المجتمع الإسلامي بالعدل وفقاً لحكم الله تعالى.18 وجدير بالذكر أن إقامة الخلافة هو واجب على المسلمين بإجماع العلماء.19فما أحوجنا إلى حضارة إسلامية مستقلة وموحّدة قادرة على تحقيق الازدهار والأمن والاكتفاء الذاتي، وحلّ معظم المشاكل التي تواجه الأمة، في ظل الأزمات العديدة التي تواجهها العديد من دول العالم الإسلامي اليوم.20
على مدار القرن الماضي وقبل وبعد سقوط الخلافة العثمانية عام ١٩٢٤م، برزت الدعوات المعاصرة لإقامة التضامن الأمتيّ في العديد من المبادرات، وبرزت مشاعر التوق إلى الوحدوية الإسلامية خلال أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وجادل بعض العلماء بأن ظهور هوية إسلامية جامعة لم يكن أكثر من مجرد محاولة لحشد المسلمين ضد الهيمنة الغربية التي كانت تتوسع بشكل سريع في الأيام الأخيرة للخلافة الإسلامية، التي ابتلي فيها المسلمون ابتلاءات شديدة، في حين أشار آخرون إلى أن الوحدة السياسية متأصّلة في الإسلام رغم كونها لم تُطبّق دائماً على أرض الواقع.21 ومع ذلك، بدا نداء الوحدة الإسلامية الذي أطلقه السلطان عبد الحميد الثاني، الذي يقال إنه كان آخر خليفة فعلي للمسلمين، نداءً صادقاً، لأن «تركيزه على مفهوم الأمة وقضاياها أدّى إلى زيادة الشعور بالتضامن الروحي المشترك بين المسلمين المتباعدين جغرافياً، حتى لو لم يتحقّق هذا التضامن بأي شكل واقعي».22
في سياق العداء الدولي الذي ساد في القرن التاسع عشر، كانت فكرة الوحدة الإسلامية حجة قوية، حيث إن التعاون السياسي والعسكري بين المسلمين كان سيمنحهم فرصة أفضل لمقاومة الإمبراطوريات الأوروبية.23 لقد أدّى سقوط الخلافة والوحدة الرمزية التي مثّلتها إلى ردود فعل قوية من زعماء المسلمين والجماعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، فقد نظر مسلمو الهند إلى الخليفة العثماني باعتباره حامياً لجميع المسلمين. وبدا ذلك صريحاً للغاية في «حركة الخلافة» الإسلامية التي حشدت المسلمين الهنود للدفاع عن الخلافة كجزء من حركة إسلامية هندية أكبر مناهضة للاستعمار، وطالبت الحركة بتشكيل مجلس دولي منتخب يضم ممثلين عن كل الدول الإسلامية للقيام بمهام الخلافة.24 خلال هذه الفترة، عُقدت العديد من المؤتمرات الدولية للمطالبة بإعادة منصب الخليفة، حتى وإن أدّى ذلك إلى تنصيب أفراد تنافسوا فيما بينهم على المنصب.25 ففي مصر، دافع مؤسّس جماعة الإخوان المسلمين في أواخر عشرينيات القرن العشرين الإمام حسن البنا (ت ١٩٤٩م) بحماس عن الهوية الأمتيّة، واقترح قيام الدول الإسلامية بتشكيل منظّمة للتعامل مع مشاكلها، مستنداً إلى فكرة دعا إليها الشاعر الكبير محمد إقبال في رؤيته للأمة لتشكيل عصبة الأمم الإسلامية.26 وعلى نحو مماثل، اقترح زعيم الجماعة الإسلامية التي تأسّست في أوائل أربعينيات القرن العشرين مولانا سيد أبو الأعلى المودودي (ت ١٩٧٩م) تشكيل نسخة إسلامية من الكومنولث، لتوحيد الأمة خارج باكستان. لقد كان لكل من الإخوان والجماعة الإسلامية تأثير كبير في استثارة المشاعر الأمتيّة في منطقتي الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، ولا تزالان حتى اليوم تحظيان بقدر كبير من التأثير.
لكن هذا الحماس لاستعادة الخلافة تضاءل خلال فترة ما بين الحربين العالميتين، وظلّ خاملاً خلال مرحلة دول «الاستقلال» ما بعد الاستعمار، حيث هيمنت المشاعر القومية على الدول الإسلامية التي نشأت حديثاً. أصبح إحياء الخلافة المشروع السياسي الأساسي لحزب التحرير الذي أسّسه الشيخ تقي الدين النبهاني في فلسطين في أوائل الخمسينيات،27 وبرز الفقيه المصري الدكتور عبد الرزاق السنهوري كأحد أهم المدافعين المعاصرين عن الخلافة واضعاً نظرية لرؤية منهجية لإقامة خلافة حديثة تضمن حقوق غير المسلمين والعلاقة مع الدول المجاورة غير الإسلامية.28 بينما أشارت جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية إلى إقامة الخلافة باعتباره هدفاً بعيداً، وإن بدا وكأنهما أرجأتا ذلك الهدف بسبب الاعتبارات السياسية البراجماتية للدول القومية التي تعمل فيها. كما شدّدت تيارات إسلامية عالمية مؤثّرة أخرى، مثل الطرق الصوفية الجشتية والنقشبندية والتيجانية وجماعة الدعوة والتبليغ، أيضاً على أهمية الوحدة الأمتيّة ووصلت دعوتها إلى ملايين المسلمين عبر العالم.
وفيما يتفق العديد من المسلمين مع فكرة الوحدة السياسية للأمة، إلا أنه لم يعد واضحًا كيفية تحقيقها اليوم. إن إعادة التفكير في نظام الخلافة وتأسيسه في القرن الحادي والعشرين ليست بالمهمة السهلة، وتثير العديد من الأسئلة حول تصورها وإحيائها بالنظر إلى النظام الدولي السائد حالياً. ويبدو أن الخلافة باعتبارها اتحاداً لحكومات بلدان المسلمين الأساسية تشكّل إحدى الطرق المنطقية لربط البلدان ذات التاريخ المشترك لتوفير الاستقرار السياسي والاقتصادي لها بطريقة تشبه الاتحاد الأوروبي. ويمكن مقارنة هذا بالنموذج الذي دعا إليه الفيلسوف السياسي عبد الوهاب الأفندي في كتابه «لمن تقوم الدولة الإسلامية؟»، حيث اقترح أن هذه الدولة قد تتخذ شكل «نظام سياسي غير إقليمي… يقوم على مجتمعات متعايشة سلمياً بدلاً من الدول القومية المتناحرة القائمة على الحدود الإقليمية والتي يستعدي بعضها بعضاً».29
ويتبادر بذلك إلى الأذهان سؤال بديهي: هل يريد المسلمون اليوم فعلاً إعادة صياغة مفهوم الخلافة في القرن الحادي والعشرين؟ في كتابه الأخير «الرأي العام الإسلامي تجاه النظام الدولي: دعم الفاعلين الدوليين و الإقليميين» (Muslim Public Opinion Toward the International Order: Support for International and Regional Actors)، يؤكد عالم الاجتماع مجتبى علي عيساني أن الدراسات القائمة حول الرأي العام الإسلامي بشأن النظام الدولي فشلت في رصد مستويات التأييد الفعلي لنظام الخلافة. ويُظهِر من خلال دراسته لبيانات الاستطلاعات أن هناك دعماً كبيراً للخلافة العالمية عبر المجتمعات الإسلامية كنموذج بديل النظام الدولي30 ويبدو أن رأيه يتوافق مع البحث السابق الذي أجراه مارك تسلر في العالم العربي خلال الثمانينات والتسعينات، والذي جُمع في قاعدة بيانات باسم الحكومة والإسلام التي عملت عليها مؤسّسة كارنيغي في الشرق الأوسط (Carnegie Middle East Governance and Islam Dataset).
يؤكد العيساني أن البيانات الناتجة تشير إلى أن «الخلافة تحظى بشعبية كبيرة كنموذج سياسي بين قطاعات واسعة من المسلمين حول العالم، وتنافس شرعية النظام الدولي الحالي إن لم تكن تتفوّق عليها».31
كما يُظهر استطلاع أجرته مؤسسة Gallup عام ٢٠٠٦ بين المسلمين في مصر والمغرب وإندونيسيا وباكستان أن هذا الطموح بقي حاضراً أيضاً في الألفية الجديدة، حيث صرّح ثلثا المشاركين بأنهم يدعمون «توحيد جميع البلدان الإسلامية» في خلافة جديدة.32 لكن هذا الدعم تراوح في بعض الدول من ٣٨٪ في إندونيسيا إلى ٨٨٪ في باكستان، مما يدلّ على أن دعم نماذج بديلة للأنظمة الحاكمة يتشكّل حسب السياق الوطني.33 وتشير دراسة أجراها برنامج السياسات الدولية (PIPA) إلى أن تأييد إقامة الخلافة يرتبط بتأييد الشريعة الإسلامية، 34 فالمسلمون الذين يريدون العيش في ظل الشريعة الإسلامية هم أكثر ميلاً إلى إقامة الخلافة العالمية. وربما يعكس هذا الشعور أيضاً شوقاً إلى الحكم المسؤول وسياسات الرعاية الاجتماعية العادلة، والتي تغيب في العديد من البلدان الإسلامية. وتشير بيانات أخرى جمعتها وكالات مثل «الباروميتر العربي» إلى إلى أنه رغم الشعبية الكبيرة للديمقراطية، إلا أن فكرة الخلافة تحظى أيضاً بشعبية في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة. ويخلص العيساني إلى أن:
المسلمين يرغبون في نظام دولي فعّال يتمتعون فيه بصوت مؤثر، ويلبّي احتياجاتهم الأساسية. وهذا لا يعني بالضرورة أن دعم المنظمات الدولية يستند فقط إلى اعتبارات نفعية اقتصادية، بل إلى حاجة عامة إلى العدالة والاستقرار والرفاه والتنمية، وهي الضرورات التي تتوق إليها شعوب العالم الإسلامي.35
من المهم أيضاً الإشارة إلى أن هذه الاستطلاعات الواسعة تثير تساؤلات حول ما فهمه المشاركون من مصطلحات مثل «الخلافة» و«الديمقراطية» و«الشريعة»، كما تشير النتائج إلى الحاجة إلى مزيد من البحث لفحص مدى هذا التأييد للخلافة وما يعنيه فعلًا في هذه الدول، وكيف ستكون الأمة اليوم موحّدة سياسياً حول العالم. وثمة بعض المؤشرات التي تظهرها غرف الدردشة ومنتديات الحوار التي تناقش مفهوم الخلافة على شبكة الإنترنت، ولكنها لا يمكن الجزم بأنها تمثّل حقّاً الرأي العام دون إجراء استطلاعات رأي واسعة النطاق.36 فبالنسبة لبعض المسلمين، تشوّهت فكرة الخلافة نتيجة ممارسات تنظيمات مثل داعش والقاعدة، ويرفضها البعض على أساس ارتباطها بالتطرف، في حين يزعم آخرون أنها ليست فرضاً دينياً أو أنها ببساطة غير قابلة للتطبيق في العالم المعاصر.
إن المدافعين عن الخلافة الحديثة الأصيلة يرونها رمزاً للأمل، وقد قال عويمر أنجم في مقاله حول هذا الموضوع: «إن الحفاظ على الوضع الراهن في العالم الإسلامي هو مجرد وهم؛ أما الحلم بتغييره فليس كذلك. فالنُّظم الحالية غير إسلامية وغير أخلاقية وتعادي تحقيق مستقبل كريم للمسلمين والبشرية بشكل عام، أما الراغبون في الحفاظ عليه فهم أقلية صغيرة ومتقلصة».37 ومن الملفت أن الأنظمة الاستبدادية في الدول القوية المسلمة وغير المسلمة تعادي فكرة الخلافة كنظام حكم بديل عادل قابل للمساءلة، لأن من شأنه أن يهدّد مصالحها. بينما تشعر النخب الحاكمة في الدول الإسلامية بالتغيير الاجتماعي والسياسي، وهو أمر حتمي سيأتي مع جيل جديد من الشباب المسلم ذي التوجه الإسلامي.
GUMEES: المسلمون الحضريون المتعلّمون المتحدّثون بالإنجليزية حول العالم
هناك العديد من القضايا الصعبة التي نحتاج إلى معالجتها على المستويات الكلية والمتوسطة والجزئية، لكن من المهم أن نتذكّر أن المسلمين ازداد عددهم بشكل كبير في القرن الماضي ليصل إلى ما يقرب من ملياري نسمة، أكثر من نصفهم تحت سن الثلاثين.38 أي أننا كمسلمين نشكل حاليًا حوالي ٢٠٪ من سكان العالم، ونمتلك موارد عديدة، ولدينا مئات الملايين من الأفراد المتعلّمين الموزّعين حول العالم والمرتبطين فيما بينهم كما لم يحدث من قبل. فقد ساعدت العولمة في تعزيز المشاعر الأمتيّة من خلال إمكانيات تكنولوجيا الاتصالات الفورية والسفر والتجارة، لكنها خلقت أيضاً مشاكل معقدة لا يمكن حلها في عزلة ضمن عالم بات أكثر ترابطًا.
إن مواجهة هذه التحديات يتطلّب جهداً جماعياً كبيراً لا يمكن تحقيقه إلا إذا عزّزنا التفاعل والتعاون الاجتماعي والثقافي والديني والاقتصادي والسياسي. من المؤكّد أن لدينا الموارد الفكرية والمادية اللازمة لتحقيق ذلك، وهو ما يحدث بالفعل على بعض المستويات، ولكننا بحاجة إلى تحسين أدائنا، فالمجتمعات الإسلامية أصبحت مترابطة مع «الغرب» وبقية حضارات العالم.
يمكن رؤية حالة التكامل السياسي والاقتصادي بين الدول في حالة الغزو الروسي لأوكرانيا من خلال انعكاس مجريات الصراع بشكل مؤلم على سائر أنحاء العالم، ما أدى إلى نقص في الغذاء والتمويل والطاقة في أفريقيا.39 كما تأثّر بذلك دول مثل لبنان ومصر وليبيا وعمان والسعودية واليمن وتونس وإيران والأردن والمغرب، لأنها تعتمد على القمح المستورد من أوكرانيا مما أدّى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلًا عن انعكاسات صعبة أخرى على الدول الأكثر فقراً. ورغم هذه الظروف المعيشية الصعبة للغاية، يُوجد شعور بالأمل بمستقبل أفضل نظراً لوجود شريحة واسعة من الشباب المسلم في طليعة مسار التغيير الاجتماعي الإيجابي.40 إن الشباب المسلم يساهمون اليوم في إطلاق وسائل الإعلام الجديدة والأسواق العالمية وإنشاء حالات ثقافية تعمل على إعادة تشكيل المجتمعات، كما يشاركون في السياسة التغييرية والنشاط الاجتماعي والإحياء الديني.41
غالبًا ما يتأسّس وعي هؤلاء الشباب الاجتماعي من خلال مشاركتهم في العمل السياسي، ليصبحوا بذلك نواة لمعظم الاتجاهات الإصلاحية الاجتماعية والسياسية والدينية المختلفة في جميع أنحاء العالم.42 وقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة Alchemiya ــ النسخة الإسلامية من Netflix ــ نافيد أختر (Navid Akhtar) هذا الجيل بأنه GUMEES43، أي نخبة عالمية ملتزمة دينياً تتفوّق في مجموعة واسعة من المجالات التي تشمل الفنون والأعمال والصناعات الإبداعية والعلوم الشرعية والإعلام والصحافة والرياضة، متجاوزين بذلك ما يسمى بالمحيط الإسلامي.44 وقد مكنهم مستواهم التعليمي، ورأس مالهم الاجتماعي، والإمكانيات التكنولوجية الرقمية، من تشكيل علاقات جديدة وتوفير إمكانيات مستحدثة للتنظيم والعمل. وباعتبارهم جيلًا اجتماعيًا، فمن المتوقع أن عددهم سينمو بشكل كبير ليلعبوا دوراً مؤثّراً في التغيير الاجتماعي الإيجابي.45 كما ساعد إتقانهم للمساحات المتاحة عبر الإنترنت في إنشاء «أمة افتراضية»، وانشغلوا بتوسيع شبكة علاقاتهم والتواصل مع الشباب المسلم ممن يشاركونهم أفكارهم في كل قارات العالم، من خلال استخدام وسائل الإعلام باللغة الإنجليزية للتواصل ونشر المعرفة، ما أدى إلى إيجاد فئات مفاهيمية جديدة:
لقد انتشر الإسلام الناطق باللغة الإنجليزية جغرافياً في مختلف أنحاء العالم التي تُعدّ الإنجليزية فيها اللغة الأكثر شيوعًا، في دول كبريطانيا وأميركا الشمالية وأستراليا أو في البلدان التي يتحدث فيها الناس بالإنجليزية بنسبة ما. ويشمل هذا بالطبع جزءاً كبيراً من أوروبا، حيث ترتفع معدلات القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية حتى إن لم تكن لغة معترفة بها رسمياً، والأهم من ذلك أن هذا يشمل أيضاً العديد من المستعمرات البريطانية السابقة.46
ربما لا يكون هذا مفاجئاً نظراً لأن اللغة الإنجليزية تعتبر لغة عالمية مشتركة، ورغم جذورها الملوّثة بالاستعمار يبدو أن الإنجليزية يمكن أن تكون لغة عالمية تجمع المسلمين في حوارات مشتركة حول القضايا المحلية والدولية. والتواصل باللغة الإنجليزية لا يقلّل من أهمية اللغات الأخرى، وإنما يشير إلى قدرة هذا الجيل على الحديث بأكثر من اللغة واستخدامها بين شباب المسلمين المتعلّمين. وعلى مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، يُتوقع أن ينمو عدد المسلمين بضعف معدل النمو لدى غيرهم، وإذا استمر هذا النمو وفق الأرقام الحالية فقد يشكّل المسلمون بحلول عام ٢٠٣٠ حوالي ٢٦٪ من إجمالي عدد سكان العالم المتوقع، البالغ ٨.٣ مليار نسمة.47 ووفقًا لمركز Pew للأبحاث، فإن معدلات الخصوبة الأعلى بين عامي ٢٠١٠ و٢٠٥٠، إلى جانب تحسن الظروف الصحية والاقتصادية في الدول ذات الأغلبية المسلمة، ستؤدّي إلى نمو عدد المسلمين بأكثر من ضعف سرعة نمو عدد سكان العالم الإجمالي.48
بحلول النصف الثاني من هذا القرن، قد يتفوّق المسلمون على المسيحيين ليصبحوا أكبر مجموعة دينية في العالم. يعيش حوالي ٦٠٪ من المسلمين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويعيش حوالي ٢٠٪ منهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يشكّل الشباب أكثر من نصف عدد السكان، ويُتوقّع أن ترتفع أعداد الأقليات المسلمة في أوروبا وأمريكا بسبب الهجرة والنمو الطبيعي. فبحلول عام ٢٠٣٠، قد يصل عدد المسلمين في أوروبا إلى حوالي ٥٨ مليونًا وفي الولايات المتحدة إلى أكثر من ٦ ملايين.
سترتفع أهمية الأعداد الكبيرة من شباب المسلمين في مناطق انتشار الأقليات المسلمة مع تحولهم إلى فاعلين اجتماعيين ومشاركتهم في الحركات الاجتماعية وتوليدها، وقد يؤدي هذا التغيير الديموغرافي إلى تغيير بنية المجتمعات الغربية مع شيخوخة هرمها السكاني وانخفاض معدّلات الإنجاب نسبياً. وسيستمر الترابط العالمي في تشكيل الاتجاهات السياسية والاجتماعية لدى المسلمين الأصغر سنّاً، خاصة مع تحول «جيل ألفا» إلى مراهقين وبلوغ «جيل زد» وجيل الألفية مرحلة الشيخوخة والتأثير على مجتمعاتهم بطرق مختلفة. ويمثّل هذا تحدّياً وفرصةً في الوقت نفسه، فمن وجهة نظر متفائلة قد يتيح هذا التغير للمسلمين فرصة إثراء مجتمعاتهم من خلال المساهمة النشطة في المشاريع الاجتماعية الإيجابية.49
رغم أن بعض شباب المسلمين بدؤوا يفقدون اهتمامهم للأسف بالتزامهم الديني، يبرز توجّه معاكس بين الشباب أيضاً بحرصهم المتزايد على الالتزام بالإسلام.50 فالتشوّف إلى تشكيل هوية دينية جامعة لا يقتصر على الاهتمام بشؤون من يعيشون في مناطق الأزمات، وهو أمر مثبت تجريبياً. فعلى سبيل المثال، خلصت دراسة أجريت بين عامي ١٩٩٧ و٢٠٠٣ إلى وجود شعور قوي بـ «الوعي الأمتي» بين المسلمين في إندونيسيا وماليزيا وباكستان ومصر وإيران وتركيا،51 وعندما سُئل المسلمون عن هويتهم الذاتية احتل ارتباطهم بإخوانهم المسلمين في جميع أنحاء العالم مرتبة عالية. كما تشير العديد من استطلاعات الرأي إلى تفوّق الهوية الإيمانيّة على الهوية الوطنية، فقد أظهر استطلاع أجري عام ٢٠١٥ في ماليزيا مثلاً أن ٦٠٪ من المسلمين الملايويين عرّفوا أنفسهم كمسلمين أولاً، بينما عرّف ٢٧٪ فقط أنفسهم كماليزيين أولاً.52 لقد أظهر الإسلام في تحليل مقارن لأجيال المهاجرين من أمريكا اللاتينية وتركيا في أستراليا أنه يوفّر هوية عابرة للأعراق.53
هذا التبنّي الكبير للهوية الإسلامية لدى بعض شباب المسلمين يرجع إلى أسباب عقائدية، لكنه بالنسبة لآخرين يرجع إلى مقاساتهم التمييز، وهو ما يولّد حالة من التضامن مع محنة إخوانهم في الدين في بلدان مثل فلسطين وكشمير وبورما. وتعزّزت هذه النتائج بدراسة أجريت على شباب من الجيل الثاني من المسلمين في خمس مدن في بلجيكا وهولندا والسويد، والتي أظهرت أن العنصرية أدّت إلى ربط الهوية الشخصية بـ «الهوية الجماعية المتنازع عليها».54
إنّ هذا الجيل المتدين هو نفسه الذي يعبر عن مشاعره الأمتيّة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية الشعبية، ويوضّح عالم السياسة هشام عيدي في كتابه «موسيقى المتمردين: العرق والإمبراطورية وثقافة الشباب المسلم الجديد» (Race, Empire and the New Muslim Youth Culture) كيف تطورت الروابط بين الإسلام والموسيقى والسياسة بين أجيال مختلفة من شباب المسلمين في جميع أنحاء العالم على مدى العقود الأخيرة. ويؤكّد نتائجه سهيل دولاتزاي في كتابه «النجم الأسود والهلال» (Black Star, Crescent Moon)، حيث يشير إلى التاريخ المشترك بين المسلمين السود والناشطين المتطرّفين و«العالم الثالث المسلم»،55 وأن العديد من مغني الراب أدرجوا في كلمات أغانيهم مصطلحات إسلامية وأشاروا إلى دعمهم لقضايا المسلمي العالمية، مثل مجموعة «A Tribe Called Quest»، التي اعتنقت الإسلام علنًا في منتصف إلى أواخر التسعينيات وشكلت لاحقًا مجموعة «The Ummah».
كما يعد التضامن الأمتي سمة أساسية في كلمات أغاني الفنانين الناطقين باللغة الإنجليزية، كالمنشدَين زين بهيكا وسامي يوسف وماهر زين، رغم أن هذا النوع من الأغاني ربما بدأ في وقت مبكر مع أغنية يوسف إسلام التي تتحدث عن التضامن مع أفغانستان بعد الغزو الروسي.56
أمة افتراضية
عرف المسلمون شبكة الإنترنت منذ وقت مبكر يعود إلى أواخر التسعينات وأنشأوا عبرها منصات مختلفة مكّنت الناس من الوصول إلى مواقع الفتاوى الافتراضية والبحث في النصوص الشرعية والتواصل مع المجتمعات القريبة من أفكارهم في جميع أنحاء العالم. واستمرت هذه الاتجاهات وتصاعدت في العقدين الماضيين، مما أدّى إلى تنوع كبير في المواقع ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وتسارعت وتيرة التواصل الأمتي عبر الإنترنت وتجلّى ذلك في الانتشار الكبير لمجموعات الفيسبوك والواتساب والتيلجرام.
ولم تخلُ هذه القنوات أبداً من النقاشات التي تمسّ تطلّع المسلمين إلى التقارب أكثر، فالوعي الأمتي عبر الإنترنت بات من بين أهم الطرق للتواصل بين المسلمين حول العالم الذين طوّروا علاقات عابرة للحدود الوطنية تترجم إلى عمل جماعي، وانظر مثلًا إلى هذا التعليق أدناه:
أستخدم الفيسبوك الآن للتواصل مع قادة المجتمع، فنحن بحاجة إلى قناة تلتقي فيها العقول النشطة ويجند بعضها بعضًا لخدمة هذه الأمة، لأن لدينا مواهب مهمّشة وأعتقد أن مواقع التواصل الاجتماعي قادرة على تحرير هذه المواهب.57
يجسّد هذا التعليق كيفية استخدام عدد كبير من شباب المسلمين لوسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد عن تاريخهم وهويتهم الإسلامية، والتواصل معاً بطرق لم تكن ممكنة قبل ظهور تكنولوجيا الاتصالات الرقمية. إذ يستخدم المسلمون اللاتينيون، والمهاجرون الذين يعيشون في مناطق بعيدة عن المجتمعات الإسلامية الكبيرة، شبكة الإنترنت للارتباط بهوية إسلامية عابرة للحدود الوطنية.58 هذه الرغبة في الترابط الأمتي الافتراضي آخذة في الازدياد، وهي الطريقة الأكثر ملاءمة للتواصل مع المسلمين الآخرين رغم تضييق بعض الدول في حالات مثل الصين، التي يُقدّر عدد المسلمين فيها بنحو 20 مليون نسمة.59
كان الحجّ في الماضي هو التجمّع السنوي الكبير للمسلمين الذي يعزّز المشاعر الأمتيّة فيما بينهم، ومع كونه عبادة جماعية مشتركة فقد كان أيضاً فرصة للقاء وتبادل الأفكار على نطاق لم يكن ممكناً دون ذلك بسبب بُعد المسافات الجغرافية. وكان هذا اللقاء المباشر بين المسلمين وإخوانهم بمثابة تحقيق للأمر القرآني في قوله تعالى: ﴿لِتَعَارَفُوا﴾.60
كان السفر عبر الحدود يحدث بشكل طبيعي مع توسّع الإمبراطوريات الإسلامية وإنشاء الطرق التجارية، وساعدت الطرق الصوفية في نشر الإسلام من شبه الجزيرة العربية إلى إندونيسيا. كما ظهرت أنماط أخرى من التلاقي عبر حركات الهجرة وأنشطة العلماء والطلبة الذين يسافرون في «رحلة» لطلب العلم الشرعي.61 ولا تزال العديد من هذه الديناميكيات مستمرة اليوم وإن كان ذلك على مستوى غير مسبوق، إذ يمكن للكثير من المسلمين اليوم السفر لأجل الترفيه، وهو ما ازداد بفضل انتشار شركات السفر التي تقدّم عروض «عطلات حلال» إلى وجهات غنية بالتاريخ الإسلامي. وفي بعض الحالات، ساعدت هذه الرحلات البعض على إنشاء مشاريع تجارية والسعي إلى فرص تجارية في بلدان زاروها مثل تركيا والمغرب وماليزيا، والتي تعد من بين الوجهات الأكثر شعبية بين المسلمين للاستثمار فيها.
هذه التنمية الاقتصادية والاكتفاء الذاتي هي إحدى وسائل تمكين المسلمين وبناء الوحدة بينهم، وتتعزّز الإمكانات الكبيرة للتجارة الدولية من خلال رواد الأعمال والمستثمرين والحرفيين والمستهلكين من شباب المسلمين، الباحثين عن منتجات حلال.62
وفقًا للتقديرات الواردة في تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام ٢٠١٦/٢٠١٧، أنفق المسلمون في عام ٢٠١٥ أكثر من ١.٩ تريليون دولار، ونما هذا الرقم في عام ٢٠١٩ ليصل إلى ٢.٠٢ تريليون دولار عبر قطاعات الطعام، والأدوية، ومستحضرات التجميل، والأزياء، والسفر، والإعلام/الترفيه.63 ويشير الطلب المتزايد باستمرار على المنتجات المتوافقة مع الشريع الإسلامي وتوافر المنتجات الحلال في المتاجر الرئيسية إلى قوة «رأس المال الإسلامي». ويجادل الخبير الاقتصادي مسعود علم شودري بأن «التحول الأمتي يجب أن ينشأ من العمليات التي يدفعها السوق، وبالتالي فإن مثل هذه الصحوة ستأتي من ديناميكيات الأعمال وريادة الأعمال والتجارة وترتيب القاعدة الشعبية الإسلامية العالمية».64
وفيما يشجع ويمثل هذا الاقتصاد القائم على هوية «الحلال» قوة اقتصادية متنامية، فإن إمكاناته يجب أن تتفادى تجسيد الإسلام كسلعة وأن تكون متجذّرة في إطار أخلاقي إسلامي يقدّر التوسط الشخصي، والعدالة الاقتصادية، ويحثّ على التقليل من الإسراف وعلى احترام البيئة.
إنّ التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية يتطلّب أيضاً نهجاً أكثر استراتيجية في التعامل مع الدول التي تدعم بعضها البعض، وشكّل هذا النوع من التعاون جزءً من فكرة «السوق الإسلامية المشتركة» التي طرحها رئيس وزراء تركيا الراحل نجم الدين أربكان في فترة ولايته القصيرة في منتصف تسعينيات القرن العشرين.65 كما أراد أربكان إعادة تقديم الدينار الذهبي كعملة موحّدة للعالم الإسلامي، لتعزيز المرونة الاقتصادية والحد من الاعتماد على العملات المهيمنة مثل الدولار الأمريكي، وتجسّدت رؤيته في منظمة الدول الثمانية النامية (D-8)، التي دشّنت انطلاقتها في إسطنبول بتاريخ ١٥ يونيو/حزيران ١٩٩٧،66 وتضم دول بنجلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا، وتهدف إلى الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية وتعزيز التبادل التجاري بين أعضائها، وتتمتّع بإمكانيات كبيرة للتعاون الاقتصادي حيث تُقدّر التجارة الحالية بين أعضائها بحوالي ١٠٠ مليار دولار.67
تعد فكرة «المقاطعة الأمتيّة» شكلاً آخر من أشكال التضامن الاقتصادي الإسلامي الذي يحظى بقوة سياسية، وهو مصطلح تستخدمه عائشة كرامات بايج (Aisha Karamat Baig) لوصف حملات المقاطعة الاستراتيجية التي بدأتها المجتمعات الإسلامية كوسيلة ضغط على الشركات أو البلدان التي تنتج سلعاً تسيء للإسلام، أو تشارك في قمع المجتمعات الإسلامية.68 وأثبتت المقاطعة الاقتصادية صعوبة الشركات والدول معها لكونها مكلفة للغاية، وبدا ذلك جلياً في حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد السلع الإسرائيلية، ومقاطعة المنتجات الدنماركية عام ٢٠٠٥ في أعقاب نشر الكاريكاتيرات في صحيفة يولاندس بوستن (Jyllands-Posten)، ومقاطعة سلسلة مطاعم ماكدونالدز بعد غزو أمريكا للعراق والذي أجبر الشركة على إغلاق ٣٠٠ فرع لها في العالم الإسلامي.
إعادة التفكير في الوحدة الأمتيّة
إن تغيير واقعنا الحالي يتطلّب منا أنّ نكون قادرين على التفكير في كيفية تغيير طريقة تفكيرنا، وخاصة الافتراضات والأسس المنهجية والمنطقية التي نعتمدها، وهذا يعني أيضاً التخلّص من الافتراضات وعمليات التفكير التي تحدّ من الإبداع. وبعبارة أخرى، علينا تعزيز عقلية «القدرة على الإنجاز» وحلّ المشكلات بدلاً من العقلية المتشائمة أو الدفاعية، فتحدّي تعزيز الوحدة الإسلامية يتوقّف على نظرتنا للأمور، بأن ننظر إلى «النصف الممتلئ» وليس «النصف الفارغ». ولإعادة تصوّر التضامن الأمتي في المستقبل، فإننا بحاجة إلى رؤية أخلاقية والعمل كمجتمع أخلاقي عابر للحدود الوطنية.
وقد لاحظ الخبير الاقتصادي رودني شكسبير (Rodney Shakespeare) أن:
الأمة قادرة على تصحيح حاضرها المؤلم وبناء مستقبل مزهر إذا ما تنبهّت للخديعة التي تقيّدها،، وتحدّ من طاقاتها، وتستغلّها، وتذلّها، وتسيطر عليها، وتمنعها بكل الطرق الممكنة من تطوير إمكاناتها الكاملة. وتتعلق هذه الخدع بقضايا الاقتصاد والأخلاق والمال، وترابطها مع بعضها البعض.69
إنّ علينا أن نقدّم القدوة في أعمالنا ونجمع خبراتنا من خلال تسهيل التعاون بين الزعماء المتديّنيين والعلمانيين والخبراء في مختلف التخصصات، كما يتطلب الأمر تطوير شبكات شعبية تعمل على تطوير قيادة أخلاقية وإبداعية وذات رؤية مستقبلية تكون غير طائفية وقادرة على خلق شراكات تعاونية. وهذا يتطلّب جهداً مشتركاً وذكاءً اجتماعياً في الطريقة التي نفكر بها في حل المشاكل، إذ لا تستطيع مجتمعاتنا ومؤسساتنا وحكوماتنا حلّ المشاكل المعقدة دون اتباع نهج جماعي في التعامل معها.
هناك العديد من الأمثلة على المشاركة في حل المشاكل، مثل مشروع جالاكسي زو (Galaxy Zoo) في جامعة أكسفورد والذي حشد في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مئات الآلاف من المتطوّعين لتصنيف صور المجرات. ويشتمل هذا النهج المسمى بـ «العقل الكبير» على جمع المعلومات وتنظيمها ونشرها على نطاق واسع من خلال الحوار والنقاش،70 مستعيناً بالخبرات الجماعية من تخصّصات متعدّدة مثل الشريعة والأخلاق والسياسة والقانون والاقتصاد والعلوم ودراسات التنمية ودراسات المستقبل، فضلاً عن مجالات أخرى. كما يعني هذا النهج القدرة على ربط مختلف أنواع العوامل المؤثّرة، عبر رسم خرائط للعوامل ذات الصلة والسببية والنماذج والعلاقات، ووضعها في بنية مشتركة يمكن الرجوع إليها. غالباً ما تسير هذه العملية على شكل دائرة تعود على نفسها، وليست خطية، حيث تتضمّن التفكير النقدي والإبداع والتأمل والعمل على إيجاد حلول قابلة للتطبيق.
إنّ تطبيق نماذج التفكير الجماعي على التحّيات التي تواجهها المجتمعات الإسلامية يعني أننا بحاجة إلى إجراء تحليل عميق لهذه التحديات، والتفكير فيها بطرق مختلفة، وتجاوز أنماط التفكير الحالية التي يتضح أنها لا تعمل. وهذا بالطبع كلام سهل مقارنة بتطبيقه، لأن تطبيقه يتطلّب التعامل مع الاختلافات الطائفية والإيديولوجية والسياسية وتعزيز التحالفات بين المجتمعات، ما يعني تطوير موقف استباقي وإنشاء شبكات تنسّق استجابات تعاونية أكثر فعالية. يمكن أن تشمل القائمة المبدئية للأولويات ما يلي: تعزيز الدور الإيجابي للمؤسّسات المجتمعية القائمة- وخاصة المساجد- وتسهيل وصول الشباب والنساء إليها أكثر، وإشراكهم في مناصب القيادة وصنع القرار؛ ودعم المنظمات غير الحكومية، وإنشاء بنى تحتية وخدمات جديدة للتعامل مع التحديات الاجتماعية الملحة؛ وإقامة تعاون أكبر مع الديانات الأخرى والأقليات لزيادة التعايش السلمي ومعالجة التحديات التي تواجه مجتمعاتنا ككل. ومن الأمثلة الإيجابية على ذلك تجارب مسلمين كانوا في طليعة خدمة مجتمعاتهم المحلية أثناء جائحة كوفيد-19، فقد نشطت الشركات الإسلامية خلال تلك الأزمة في المملكة المتحدة بشكل خاص وأنشأت المطاعم والمساجد ومراكز توزيع الطعام المجاني للمشردين.
يشير المفكر والمستشرف المسلم ضياء الدين سردار إلى أن «الإسلام، في مآلاته، هو نظرة عالمية موجّهة نحو المستقبل: فهو مهتم بتحسين كلا الحياتين الدنيا والآخرة، ولذا فلا يُستغرب أن يكون للمفاهيم الأساسية للإسلام بُعد مستقبلي متأصّل».71 وطبعاً لا أحد منا يستطيع التنبّؤ بالمستقبل، ولكن يمكننا صياغة توقعات مستندة إلى التجارب السابقة. ويجب علينا التفكير فيه على أسس صلبة من أجل تشكيله. وهذا يعني فهم الاتجاهات الحالية، وكيفية تطوّر التغييرات، وماهية التحديات والفرص التي قد تتجسّد في المستقبل القريب، وكيفية التعامل مع المخاطر والاستفادة من الفرص.
كما يتطلّب الأمر فهماً عميقاً لموقعنا الحالي وأين نودُّ أن نكون بعد عشرة أو عشرين أو ثلاثين عاماً، لأن التغييرات الإيجابية في الأمة لن تأتي بين عشية وضحاها، بل ستتطلّب جهداً عالمياً حقيقياً عبر أجيال متتابعة. إننا نعيش مرحلة من التغيير المتسارع يطلق عليها سردار وصف «الأوقات ما بعد الطبيعية»، وهي «مرحلة وسيطة تموت فيها القناعات القديمة قبل أن تولد الجديدة، فيما تبدو الأشياء ذات معنى قليلة جدًا».72 هذه مرحلة تتمتّع فيها التوجهات والتقنيات والأزمات الجديدة بالقدرة على تغيير المنظور الاجتماعي والسياسي المألوف بشكل جذري، كما رأينا خلال جائحة كوفيد-١٩ والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة. وكذلك الأمر في المجال الاجتماعي، حيث يتم تحدي الأفكار المتجذرة حول الأخلاق والهوية وتغييرها بين عشية وضحاها، و«يمكن أن تظهر فيها المفاهيم والأحداث غير التقليدية وغير العادية وكأنها من العدم، ومن ثم تنتشر وتصبح هي المهيمنة».73
هذه هي الديناميكيات التي يحتاج المسلمون الساعون إلى تغيير مجتمعاتهم بشكل إيجابي إلى مراعاتها، ومن المرجّح أن يحمل العقدان المقبلان استمراراً مؤلماً للركود الاقتصادي والسياسي، وتوطيد الأنظمة الاستبدادية، والثورات، والحروب الأهلية، والتغييرات الجزئية، ما لم تحدث تغييرات دراماتيكية. وبينما تثبّت الدول الحقائق الاجتماعية من خلال تنفيذها للسياسات والقوانين، فإن عوام الناس هم الذين يتمتعون بالقدرة الفردية والجماعية على تحدّيها وتغييرها. وبدلًا من الميل إلى استثناء مشاكلنا باعتبارها فريدة من نوعها ولا يمكن التغلّب عليها، فإن علينا مقاومة هذا الميول والنظر إلى التحدّيات العالمية الأكبر، والمساعدة في مناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً بالنسبة لنا كبشر، وأن نساعد في حل المشاكل العالمية مثل الأزمة البيئية.
وهذا أمر ملحٌّ بشكل خاص، إذ يُرجّح أن تؤثّر قضايا التصحّر والتوسّع الحضري والتلوّث وعدم الاستقرار البيئي والأمراض الحيوانية المنشأ والفيضانات على البلدان الإسلامية في العقدين المقبلين، وسيكون لها تأثير لاحق على انتشار الأمراض المعدية وقدرة هذه الدول على إطعام نفسها. ولقد رأينا هذا بشكل مؤلم في بلدان تعاني من الحروب مثل اليمن، وجزر المالديف التي تواجه خطر الغرق في البحر بحلول نهاية القرن مع جزء كبير من الساحل الجنوبي لبنجلاديش. وتترتّب على تحديات المناخ عواقب تتعلّق بالهجرة ونزوح السكان، والتي قد تتفاقم إلى صراعات سياسية من شأنها أن تؤدّي إلى تزايد تدفّق اللاجئين حول العالم والذين سيكون معظمهم من المسلمين.
هذه المشاكل تضاف إلى فشل دول العالم الإسلامي في وضع سياسات اقتصادية تعالج الفقر وانعدام المساواة الاجتماعية وتوفير الاحتياجات الأساسية، كالإسكان والتعليم والتوظيف والرعاية الصحية والأمن الغذائي. كما أن معظم هذه الدول بعيدة كل البعد عن القدرة على التأثير على مسار المناقشات العلمية والتكنولوجية حول الذكاء الاصطناعي، والمراقبة الرقمية، وتكنولوجيا ما بعد الإنسان (Transhumanism)، أو التطويرات المحتملة في مجالات مثل تسلسل الجيل التالي (Next Generation Sequencing)، والبيانات الضخمة (Big Data)، والطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing)، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المدمج.
من ناحية أخرى، اتخذت الحكومات صاحبة العقليات التي تستشرف المستقبل طرقاً مبتكرة لإعادة تصوّر أنواع المجتمعات التي تريدها، فأنشأت فنلندا مثلًا «لجنة المستقبل»، وتبعتها لاحقًا «الوزارة المفتوحة» التي سمحت للشعب بالمساهمة في صياغة القوانين.74 كما قامت أيسلندا بتجربة مماثلة عندما أشرك برلمانها الوطني الشعب في عملية مفتوحة لإعادة كتابة الدستور، مع مداخلات عبر الإنترنت ولجنة تمثيلية.
عند النظر في التاريخ بمنظور أوسع، لن تكون مهمة توحيد المسلمين بعيدة المنال ولو أنها قد تبدو لنا أحياناً أقرب للمستحيل. من المفيد أن نتذكّر أن دول أوروبا خاضت حروباً فيما بينها لمئات السنين، ولم تتوصّل إلى تسوية سلمية إلا في القرن العشرين بعد حربين عالميتين وملايين القتلى. واستغرق الطريق للوصول إلى الديمقراطيات الأوروبية السلمية قروناً عديدة ولم تصل إلى ترتيب فعال لها نسبياً في شكل الاتحاد الأوروبي إلا مؤخراً، والذي يمر حالياً بفترة متقلبة مع تصاعد مشاعر اليمين المتطرف والشعبوية وانتخاب الساسة الاستبداديين.
ولطالما شهد التاريخ حالات من الانعكاسات الدرامية التي يصبح فيها المستحيل ممكناً، إذ لم يتوقع مهندسو الإمبراطوريات الأوروبية قط أن أحفاد الشعوب التي غزوها سيسكنون قارتهم ذات يوم بعشرات الملايين، وأن المسلمين سيكون لهم مثل هذا الحضور الكبير. ومن كان ليتصور قبل ثلاثين عاماً أن تركيا العلمانية المتطرفة ستتبنّى سياساتها الحالية في مجال أسلمة الدولة، وأن السعودية المحافظة ستتحول نحو العلمانية باسم «الحداثة»؟!
إن التغيير الذي نسعى إلى تحقيقه لن يحدث بمجرد الحديث والاحتجاج والتنديد بالظلم، بل يتعين علينا أن نشارك في عملية البناء بقدر انخراطنا في النقد. ولذا، يقول الناشط الرائد في الحوار بين الأديان إيبو باتيل: «من السهل انتقاد أهل السلطة، ولكن الأمر مختلف عندما تكون أنت المسؤول عن رفاهية الآخرين. هل ستتحسن حياة الناس عندما تكون أنت من يدير الأمور؟…من الممكن أن تحتج على الأشياء السيئة حتى تختفي، ولكن إذا كنت ترغب في إحداث شيء جيد، فعليك أن تصنعه بنفسك».75 ولا شك أن الثمار التي نود أن نقطفها في المستقبل، تبدأ بغرس البذور اليوم.
إن الطموح نحو الوحدة الإسلامية ليس ممكناً فحسب، بل هو قابل للتحقيق ويبدأ في مجتمعاتنا من خلال التواصل مع من لديهم وجهات نظر مماثلة والتعلم للعمل على القضايا التي تعود بالنفع على مجتمعاتنا المسلمة. ورغم أن لدينا عدداً كبيراً من العلماء والأطباء والأكاديميين من الطراز العالمي، إلا أننا نفتقر إلى المفكرين المبدعين والمثقفين متعددي المعارف القادرين على تقديم وجهات نظر ثاقبة، واستخدام معرفتهم لتطوير رؤى فريدة أو حلول إبداعية للتحديات المعقدة والمتعددة الأبعاد.
إننا بحاجة لتجاوز خلافاتنا والنظر في التواصل مع من قد يحملون وجهات نظر مختلفة، ولكنهم يتفقون معنا على حاجتنا إلى الوحدة بين المسلمين وضرورة العمل معاً لمعالجة القضايا ذات الاهتمام الجماعي. ويعني هذا في الممارسة العملية البحث عن فرص للمشاركة في المنتديات التي تجمع المسلمين معاً على المستويين المحلي والإقليمي، وقد أنشأنا البنى الأساسية والشبكات القادرة على تعزيز التواصل والتعاون الأمتيّ.
والكثير من هذا حاصل بالفعل على المستويين الإقليمي والوطني في معظم المجتمعات الإسلامية، ويمكن تعزيزه من خلال التنسيق الأكثر فعالية وتبادل المهارات والموارد، كما يجب تسليط الضوء على التجارب الجيدة والاحتفاء بها. ففي المملكة المتحدة، أثبت المجلس الإسلامي البريطاني (Muslim Council of Britain) أنه المنصة الرائدة التي تضم أكثر من 500 مسجد ومنظمة إسلامية تابعة له، ونجح في الضغط من أجل مجموعة من القضايا وكان بمثابة الواجهة المؤسسية الرئيسية بين الحكومة والجالية المسلمة في بريطانيا.
وفي الولايات المتحدة، توجد العديد من الهيئات الوطنية الكبيرة مثل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR)، والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)، والدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية (ICNA)، والرابطة الإسلامية لأمريكا الشمالية (Mana)، والتي توفر منصات تمكّن من تبادل الأفكار والخبرات وتمثّل المسلمين الأمريكيين في عموم المجتمع الأمريكي.
وفي أوروبا، هناك منظمات مثل مجلس المسلمين الأوروبيين (Council of European Muslims)، والاتحاد الدولي للمسلمين الأوروبيين (FIOE)، ومنظمة المرأة المسلمة الأوروبية (FEMYSO)، والمنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة (European Forum of Muslim Women)، وهي هيئات تابعة تساعد على نحو مماثل في دعم المسلمين الأوروبيين على المستوى القاري. وهناك مجموعات ومبادرات مماثلة في كل أنحاء العالم، لكننا بحاجة إلى تعاون استراتيجي أكبر بكثير.
إن الحاجة إلى تعزيز المنصات الدولية القادرة على تحفيز الوحدة الأمتيّة تُعد تحديًا أكثر صعوبة، ولعل منظمة التعاون الإسلامي تتمتع بأكبر قدر من الإمكانات في هذا الشأن. حيث سعت في البداية إلى تعزيز «التعاون الوثيق وتبادل المساعدات في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والروحية، مستلهمة من تعاليم الإسلام الخالدة».76 ورغم الانتقادات التي وُجّهت إلى المنظمة بسبب عدم فعاليتها نتيجة الانقسامات حول الأهداف والمنافسة بين الدول الأعضاء، فقد كان لها بعض التأثير الإيجابي من خلال بنك التنمية الإسلامي، وصندوق التضامن الإسلامي، وتمثيل وجهات النظر الإسلامية في المنتديات الدولية كالأمم المتحدة.77 والحقيقة أن مجرد استمرار المنظمة حتى الآن يؤكد الحاجة القوية إلى المؤسسات الإسلامية العابرة للحدود الوطنية، ولا تستطيع هذه المنصات العالمية الاستمرار في مزاولة أعمالها كالمعتاد لكونها بحاجة للتعامل مع المخاوف التي أثيرت بشأنها.
الخلاصة: «ما يوحّدنا أعظم مما يفرقنا»
ينطبق المثل المذكور أعلاه على المسلمين بشكل خاص، فالأمة الإسلامية- كما لاحظ أنور إبراهيم- تقدّم لنا من حيث المفهوم والممارسة عبر التاريخ دليلاً واضحاً على التنوع داخل وحدتها السياسية.78 فتاريخ الحضارة الإسلامية شاهد على تنوّعه الغني بين الشعوب والثقافات والتقاليد، ومن المؤسف أن انقسام المسلمين اليوم لا يزال يعيق الجهود الرامية إلى جمع المسلمين. وكما لاحظ بعض العلماء، فإن المسلمون منقسمون اليوم على أسس طائفية وعقائدية ووطنية قومية، والتوتّرات بين السنة والشيعة، والسلفيين والصوفيين، والتنافس بين السعودية وإيران، كل ذلك يقوّض محاولات الوحدة الإسلامية.79
ورغم تجذّر هذه الاختلافات، فإن هناك العديد من المحاولات المثمرة الجارية لجمع التيارات الإسلامية المتنوعة. ففي عام ٢٠٠٥ مثلًا، دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إلى عقد مؤتمر دولي لإصدار «إعلان عمان» الذي وقع عليه ٥٥٢ عالماً ومفكراً دينياً من أربعة وثمانين دولة، هدفه مواجهة صعود الأفكار الإسلامية المتطرفة والاعتراف بالفرق الدينية والمذاهب الفكرية المتنوعة بين المسلمين. وقد اقترح العالم المؤثر الراحل الشيخ يوسف القرضاوي «مبادئ للحوار السني الشيعي»،80 كما أصدرت مرجعيات شيعية بارزة مثل آية الله علي خامنئي في إيران وعلي السيستاني في العراق العديد من الفتاوى التي تحرّم التعرض للرموز والمقدسات السنية.81
يمكن ملاحظة هذه الرغبة في مزيد من جهود التقريب بين السنة والشيعة في المجتمعات الإسلامية الغربية مؤخّراً. ففي المملكة المتحدة، أصدر المجلس الإسلامي البريطاني، والمجلس الاستشاري الوطني للمساجد والأئمة (Mosques and Imams National Advisory Board)، ومؤسسة الخوئي، والرابطة الإسلامية البريطانية (Muslim Association of Britain)، ومجلس الجماعة الأوروبية، ومجلس علماء الشيعة في أوروبا بياناً مشتركاً حول التضامن والوحدة الإسلامية.82 كما أُطلقت مبادرة مهمة أخرى في أوائل عام ٢٠٢٢ تحت عنوان «ميثاق الأئمة والعلماء حول العالم» (Global Imams and Scholars Charter)، كجهد للعمل نحو توحيد الرؤية بين المنظمات والأئمة والعلماء في الغرب،83 والهدف الأساسي منها السعي إلى تحسين واقع الأمة من النواحي الروحية والاجتماعية والأخلاقية والفكرية. وتشمل المبادرة حالياً هيئة العلماء والأئمة البريطانية (British Board of Scholars & Imams)، والمجلس الأوروبي للأئمة (European Council of Imams)، واتحاد الأئمة في أمريكا الشمالية (North American Imams Federation)، والمجلس الكندي للأئمة (Canadian Council of Imams)، والمجلس الوطني للأئمة في أستراليا (Australian National Imams Council)، ومجلس علماء نيوزيلندا (Ulama Council of New Zealand)، ومجلس علماء جنوب أفريقيا (United Ulama Council of South Africa). فالتعاون العلمي الهادف والسعي نحو جمع الكلمة مهمان للغاية في الجمع بين التوجهات الإسلامية المختلفة، وتشكّل هذه المنصات أساساً يمكن البناء عليه.
رغم التفتّت السياسي والاجتماعي المستمر في العالم الإسلامي، لا يزال الشعور الأمتي آخذاً بالنمو. فالمسلمون يتقاربون بينما يتباعد الآخرون بوضوح ويضخّمون الانقسامات القائمة فيما بينهم، وعلى عكس «المجتمعات الوهمية» للدول القومية الحديثة فإن الرغبة في الوحدة الأمتيّة هي رغبة حقيقية.84 وبالنسبة للعديد من المسلمين، فإن روابط الإيمان مهمة كروابط الدم، لكن مهمتنا هي تعزيز هذه الروابط وإنشاء سرديات مضادة جديدة تحوّل الحوار نحو التعاون الوظيفي والمستدام والفعال بين المسلمين. نحن بحاجة لندرك أن الرغبة في الوحدة ربما تكون أقوى وأكثر ضرورة الآن من أي وقت مضى في تاريخنا، إذ تشير ملامح الأشكال المتنوعة للوعي الأمتي، التي سُلّط الضوء عليها في هذا المقال، إلى نقاط الانطلاق نحو المزيد من التطوير، وهي نقاط واعدة نظراً لأن معظم المسلمين في العالم هم دون سن الثلاثين. فالشباب المسلم ليسوا مجرد أمل للمستقبل بل هم أيضاً صناع التغيير الرئيسيون حالياً، ونحن بحاجة إلى تعزيز إمكانات الملايين منهم الذين يعملون في مجالات ريادة الأعمال، والابتكار التجاري، والتكنولوجيا، والتعليم، والنشاط الاجتماعي، والفن، والصحافة، والذين يغيرون بالفعل مجالاتهم، وتشجيعهم على التفكير والعمل بطرق أمتيّة أكثر.
كما أننا بحاجة إلى البدء في جمع أفضل العلماء والمفكرين والكتاب ومحللي السياسات والأكاديميين والناشطين وعوام المسلمين، من كل أبناء الأمة، المستعدين لتجاوز الطائفية والسياسات التافهة وتعزيز الصالح العام للمساهمة في تعزيز الوحدة الإسلامية. ندرك جميعاً انقسامنا الشديد بشأن العديد من القضايا، ولكن هناك شيء واحد يجب أن نتفق عليه جميعاً وهو الحاجة الملحة إلى وحدة أمتيّة أكبر. لا ينبغي لنا أن نقلل من شأن العدد الكبير من المسلمين في جميع أنحاء العالم، الذين يفكرون بنفس الطريقة ويبحثون ويعملون على تغيير الوضع الراهن بطرق إيجابية، فهؤلاء العاملون المتشابهون في التفكير سيساعدون في تحديد السبل لمعالجة تحدياتنا الجماعية وتطوير الإجماع حول القضايا الرئيسية وتحويل التحليل إلى عمل. ونحن لدينا بالفعل الأسس والتطلعات فدعونا نبني عليها، ولن نتوحّد بفرض التوحيد من الأعلى، ولكن من خلال تطوير المزيد من الجهود الموحدة من الأسفل. وبالتالي، فإن التحدّي لا يزال قائماً: إن كنا نريد أمة أكثر وحدة فهل نحن على استعداد للعمل من أجلها؟
* * *
الاقتباس المقترحة:
صادق حامد، «إسلام يتجاوز الحدود: بناء التضامن الأمتي في القرن الحادي والعشرين»، ترجمة أنس خضر، أمّتكس، ا أغسطس ٢٠٢٥، https://ar.ummatics.org/islam-beyond-borders
هوامش
-
Faisal Amjad, “A recipe to reunite the Ummah: What has Gordon Ramsay got to do with Muslim unity?” Medium, June 16, 2022, https://medium.com/kn-ow/how-gordon-ramsay-can-reunite-the-ummah-b977836f7d32.
-
Miriam Cooke and Bruce B. Lawrence, Muslim Networks: From Hajj to Hip-Hip (North Carolina: University of North Carolina Press, 2006), 1.
-
للاستزادة في هذا الموضوع، انظر:
Peter Mandeville, “Muslim Transnational Identity and State Responses in Europe and the UK after 9/11: Political Community, Ideology and Authority,” Journal of Ethnic and Migration Studies 35, no. 3 (March 2009): 491-506.
-
Ejaz Akram, “Muslim Ummah and its Link with Transnational Muslim Politics,” Islamic Studies 46, no. 3 (Autumn 2007): 381-415.
- «معظم المسلمين يريدون الديمقراطية والحريات الشخصية والإسلام في الحياة السياسية، وقليلون هم من يعتقدون أن الولايات المتحدة تدعم الديمقراطية».
Pew Research Centre, Global Attitudes Project, July 12, 2012, p.3.
-
“Malaysia premier calls for ‘Islamic renaissance’ with these two countries,” The New Arab, July 28, 2019, https://www.newarab.com/news/malaysia-premier-calls-islamic-renaissance-two-countries.
-
Anwar Ibrahim, SCRIPT For a Better Malaysia an Empowering Vision and Policy Framework for Action (Shah Alam: Institut Darul Ehsan and Centre for Postnormal Policy and Futures Studies, 2022).
-
Salman Sayyid, “The Crescent of Hope,” Daily Sabah, Sept 10, 2018, https://www.dailysabah.com/op-ed/2018/09/10/the-crescent-of-hope.
-
James Piscatori and Amin Saikal, Islam Beyond Borders: The Umma and World Politics, (Cambridge University Press, 2019), viii.
-
Md. Kamaruzzam, “Profile – Bangladeshi fighter pilot who destroyed Israeli planes,” Anadolu Agency, June 15, 2020, https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/profile-bangladeshi-fighter-pilot-who-destroyed-israeli-planes/1877614.
-
Ehsan Abdullah, “Remembering the Past: Bangladeshi Fighters for Palestine of the 1980’s, May 23 2018, https://mygoldenbengal.wordpress.com/2018/05/23/remembering-the-past-bangladeshi-fighters-for-palestine-of-the-1980s-2/.
- من المهم أيضاً أن نتذكر التوترات السابقة التي دارت حول مفهوم الهوية خلال هذا الحدث العالمي، وللحصول على تحليل دقيق للأبعاد المغربية والأفريقية والعربية والإسلامية في أداء المنتخب المغربي في كأس العالم، انظر:
Hisham Aïdi, “The (African) Arab Cup,” Africa is a Country, December 13, 2022, https://africasacountry.com/2022/12/the-afro-arab-cup.
-
Daniel Harris, “World Cup 2022 briefing: Morocco’s pride in Islam should inspire us all,” The Guardian. December 14, 2022, https://www.theguardian.com/football/2022/dec/14/world-cup-2022-briefing-moroccos-pride-in-islam-should-inspire-us-all.
-
للاطلاع على دراسة استقصائية مفيدة حول هذا الموضوع، انظر:
Marie Juul Petersen, For Humanity or for the Umma? Aid and Islam in Transnational Muslim NGOs (London: C. Hurst & Co., 2015).
-
Mazen Hashem, “The Ummah in the Khutba: A Religious Sermon or a Civil Discourse?” Journal of Muslim Minority Affairs 30, no. 1, (March 2010).
-
Rashid Dar, “America is a Caliphate,” Popula, Sept 11, 2018, https://popula.com/2018/09/11/america-is-a-caliphate/.
-
لمناقشة موسعة انظر:
Ovamir Anjum, “Who Wants the Caliphate?”, Yaqeen Institute, 2019, https://yaqeeninstitute.org/read/paper/who-wants-the-caliphate.
- للتعرّف على المشاكل التي تواجه الدول ذات الأغلبية المسلمة وأسسها المتأصّلة في الدولة القومية الحديثة، والتي لا زالت تبقيها منقسمة وضعيفة، انظر:
Joseph Kaminski, “Irredeemable Failure: the Modern Nation-State as a Nullifier of Ummatic Unity,” Ummatics Institute, December 14, 2022, https://ummatics.org/2022/12/14/irredeemable-failure-the-modern-nation-state-as-a-nullifier-of-ummatic-unity/.
-
Jacob M, Landau. The Politics of Pan-Islamism: Ideology and Organization, (Oxford: Oxford University Press, 1990), 2-4.
-
Özcan A. Pan-Islamism: Indian Muslims, the Ottomans & Britain (1877-1924) (London: Brill, 1997), 62.
- للاستزادة، انظر مثلًا:
Birol Baskan and Ömer Taspinar, The Nation or the Ummah: Islamism and Turkish Foreign Policy, (Albany, NY: State University of New York Press, 2021).
- Özcan, Pan-Islamism, 62.
- انظر:
Basheer Nafi, “The Abolition of The Caliphate in Context,” in Demystifying The Caliphate: Historical Memory and Modern Contexts, eds. Madawi al-Rasheed et al., 31-56.
-
Abdullah Ahsan, Ummah or Nation: Identity Crisis in Contemporary Muslim Society (Leicester, UK: Islamic Foundation, 1994), 88.
في عام ٢٠١١، عبّر المفكّر الكويتي المنتمي للإخوان المسلمين طارق سويدان عن تأييده لفكرة «الاتحاد الإسلامي»، انظر:
Noha Mellor, Voice of the Muslim Brotherhood: Da’wa, Discourse, and Political Communication, (London: Routledge, 2018).
- كانت هناك حركات مماثلة مثل الجماعة الإسلامية التي تأسّست في باكستان في منتصف السبعينيات. لمزيد من الأمثلة، انظر:
Reza Pankhurst’s The Inevitable Caliphate? A History of the Struggle for Global Islamic Union, 1924 to the Present (London: C. Hurst & Co., 2013).
- لملخّص حول هذا الرأي، انظر:
Yoginder Sikand, “Review of Who Needs an Islamic State”, Counter Currents, 15 July, 2009, https://www.countercurrents.org/sikand150709.htm.
-
Mujtaba Ali Isani, Muslim Public Opinion Toward the International Order: Support for International and Regional Actors (Cham: Palgrave-MacMillan, 2019).
-
“What’s the appeal of a caliphate?” BBC News, 26 October, 2014, https://www.bbc.co.uk/news/magazine-29761018.
- Isani, 28.
- Isani, 89.
- Isani, 3.
-
Julia Voelker McQuaid, The Struggle for Unity and Authority in Islam: Reviving the Caliphate? (A joint CNA/Wilton Park Conference) 2007, Center for Strategic Studies, Virginia, p.23-24.
-
“Religion by Country 2023,” World Population Review, https://worldpopulationreview.com/country-rankings/religion-by-country.
-
Edward A. Burrier, “In Africa, Putin’s War on Ukraine Drives Food, Fuel and Finance Crises,” United States Institute of Peace, June 30, 2022, https://www.usip.org/publications/2022/06/africa-putins-war-ukraine-drives-food-fuel-and-finance-crises.
- انظر مثلًا:
Juan Cole, The New Arabs: How the Millennial Generation is Changing the Middle East, (Simon & Schuster, 2014), and Tahir Abbas and Sadek Hamid (Eds) Political Muslims: Understanding Youth Resistance in a Global Context, (Syracuse University Press, 2019).
- انظر مثلًا:
Herrera, Linda, and Asef Bayat, eds. 2010. Being Young and Muslim: New Cultural Politics in the Global South and North. Oxford University Press, Ahmad, Fauzia, and Mohammed S. Seddon, eds. 2012. Muslim Youth: Challenges, Opportunities, and Expectations. London: Continuum, Masquelier and Soares 2016.
- انظر مثلًا:
Hisham D Aidi, Rebel Music: Race, Empire and New Muslim Youth Culture (Pantheon Books, 2014).
- أُشير إلى هذه الفئة أيضاً باسم: «الجيل م» في كتاب:
Shelina Janmohammed, Generation M: Young Muslims Changing the World (London: I.B Tauris, 2016).
ويشير موقع Creative Ummah إلى هذا الاتجاه في المجال الأنجلوسكسوني.
-
Daniel Nilsson DeHanas and Peter Mandaville, Mapping the Muslim Atlantic: US and UK Debates on Race, Gender and Securitization, London: British Council, 2019.
-
Janmohammed, Generation M. See also William Barylo, Young Muslim Change Makers: Grass Roots Charities Rethinking Modern Societies (London: Routledge, 2018).
-
Abdul-Azim Ahmed, “Anglophone Islam: A New Conceptual Category.” Contemporary Islam 16, no. 2-3 (2022): 135-154.
-
Brian Grim and Mehtab Karim, The Future of the Global Muslim Population: Projections for 2010-2030, Pew Research Center Forum on Religion & Public Life, https://www.pewresearch.org/religion/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/, p.13.
-
Grim and Karim, The Future of the Global Muslim Population, 13.
- انظر مثلًا:
Garbi Schmidt, “Islamic Identity Formation among Young Muslims: The Case of Denmark, Sweden and the US,” Journal of Muslim Minority Affairs 24, no. 1 (2004): 31-45.
-
Riaz Hassan, “Globalisation’s Challenge to the Islamic ‘Ummah’,” Asian Journal of Social Science 34, no. 2 (2006): 311–23.
-
Teo Cheng Wee, “More Malays Say They Are Muslim First: Malaysian Poll,” Straits Times, August 12, 2015,www.straitstimes.com/asia/se-asia/more-malays-say-they-are-muslim-first-malaysian-poll.
-
Zuleyka Zevallos, “‘You Have to be Anglo and Not Look Like Me’: Identity and belonging among young women of Turkish and Latin American backgrounds in Melbourne Australia,” Australian Geographer 39, no. 1 (2008): 21-43.
-
Fenella Fleischmann, Karen Phalet, and Olivier Klein, “Religious Identification and Politicization in the Face of Discrimination,” British Journal of Social Psychology 50, no. 4 (2011): 628-648, at 629.
-
Sohail Daulatzai, Black Star, Crescent Moon: The Muslim International and Black Freedom beyond America (University of Minnesota Press, 2012), xxiix.text-
-
Yusuf Islam – Afghanistan, Nasheed Lovers Blog, December 30, 2008, http://nasheedlovers.blogspot.com/2008/12/yusuf-islam-afghanistan.html.
-
Nasya Bahfen, “The Individual and the Ummah: The Use of Social Media by Muslim Minority Communities in Australia and the United States,” Journal of Muslim Minority Affairs 38, no. 1 (2018): 7.
-
Diana Carolina Zuniga Gomez and Mehmet Ozkan, “(Dis)Connecting with the Ummah in e-Spaces: How Latino Muslims Shape Their Identity Through the Internet,” Journal of Muslim Minority Affairs 40, no. 2 (2020): 302-317.
-
Ho Wai-Yip, “Emerging Islamic-Confucian Axis in the Virtual Ummah: Connectivity and Constraint in Contemporary China,” Comparative Islamic Studies 7, no. 1-2 (2011): 137-155.
- يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾. الحجرات: 13.
- هناك عدد لا يحصى من المواقع الإسلامية التي تروج للمنتجات والخدمات التجارية التي تعزز المفاهيم الإيمانية ومركزية مفهوم الأمة، على منصات مثل:
-
Ifty Islam and Muzahid Khan. Capturing the Halal Pound: A Global Business Growth Opportunity, Janala Ventura, August 19, 2021, https://janalaventura.com/knowledge-insights/.
-
Masudul Alam Choudhury, The Islamic World System: A Study in Polity and Market Interaction (London: Routledge, 2004), xxii.
-
Cengiz Dinç, “The Welfare Party, Turkish Nationalism and Its Vision of a New World Order,” Alternatives: Turkish Journal of International Relations 5, no. 3 (2006): 1-17.
- لمزيد من المعلومات، راجع موقع المنظمة على الإنترنت:
-
Md. Kamaruzzam, “D-8 leaders vow to enhance trade among member states,” Anadolu Agency, April 8, 2021, https://www.aa.com.tr/en/politics/d-8-leaders-vow-to-enhance-trade-among-member-states/2202874.
-
Aysha Karamat Baig, Ummatic Macro-Boycott Motives: A Socio-Cultural Perspective, unpublished PhD, (Malaysia: Swinburne University of Technology, 2019).
-
Rodney Shakespeare, Foreword in Masudul Alam Choudhury, The Islamic World System, xii.
-
Geoff Mulgan, Big Mind: How Collective Intelligence can Change our World (Princeton: Princeton University Press, 2018).
-
Sardar, Ziauddin, Jordi Serra, and Scott Jordan, Muslim Societies in Postnormal Times: Foresights for Trends, Emerging Issues and Scenarios (United Kingdom: International Institute of Islamic Thought and Centre for Postnormal Policy & Futures Studies, 2019), 5.
-
Ziauddin Sardar (ed.), The Postnormal Times Reader (Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, Centre for Postnormal Policy & Futures Studies, and MAHYA, 2020), 5, https://iiit.org/wp-content/uploads/BiB-The-Postnormal-Times-Reader-Combined.pdf.
- لمزيد من المعلومات، انظر:
“Committee for the Future,” Parliament of Finland, https://www.eduskunta.fi/EN/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/Pages/default.aspx.
-
Eboo Patel, “Our World Needs Social Change Agents: Here’s how to be an Effective Activist,” Chicago Tribune, July 18, 2022: https://www.chicagotribune.com/opinion/commentary/ct-opinion-activism-interfaith-coalition-bridge-building-20220718-q7uyai5lejhwbe6bkk7v5fupoi-story.html.
-
OIC General Secretariat, “Declarations of the First Islamic Summit Conference,” OIC Declarations and Resolutions of Heads of States and Ministers of Foreign Affairs Conferences 1389-1401 H. (1969-1981), n.d., p.18, cited in Abdullah Ahsan, Ummah or Nation: Identity Crisis in Contemporary Muslim Society, (Leicester, UK: Islamic Foundation, 1992), 108.
-
في ديسمبر ٢٠١٩، انعقد مؤتمر كوالالمبور في ماليزيا بحضور ٢٠ دولة إسلامية لمناقشة قضايا الوحدة والتعاون بين المسلمين. لمزيد من الاطلاع، انظر:
Mohammad Hashim Kamali, “Kuala Lumpur Summit on a Unified Currency for Muslim Countries,” IAIS Bulletin 53 (Nov-Dec 2019), 3-4.
-
Anwar Ibrahim, “The Ummah and Tomorrow’s World,” Futures 23, no. 3 (April 1991): 302-310, at 306.
-
Sagi Polka, “Taqrib al-Madhahib — Qaradawi’s Declaration of Principles Regarding Sunni-Shi’i Ecumenism,” Middle Eastern Studies 49, no. 3 (May 2013): 414-429.
-
Ali Mamouri, “Shiite leaders forbid insults against Sunnis,” Al-Monitor, January 13, 2015: https://www.al-monitor.com/originals/2015/01/iran-iraq-fatwa-sunni-shiite-insults.html.
-
“Joint Statement on Muslim Solidarity and Unity,” MCB, May 14, 2013, https://mcb.org.uk/mcb-updates/joint-statement-on-muslim-soldarity-and-unity/.
-
“The Global Imams & Scholars’ Charter – The Global Imams & Scholars Network”, The British Board of Scholars & Imams, April 30, 2022, https://www.bbsi.org.uk/the-global-imams-scholars-charter-the-global-imams-scholars-network/.
-
Benedict R. Anderson, Imagined Communities: Reflections on The Origin and Spread of Nationalism (London: Verso, 1991).